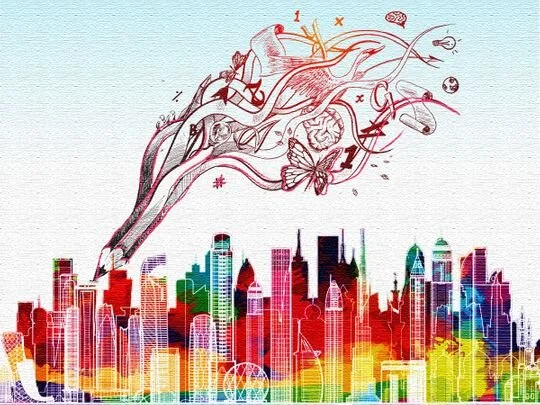!الدافعية: مُحرك السلوك ومصنع العظماء
نحو استراتيجية وطنية للابتكار الحكومي
الابتكار المزعزع
الذكاء العاطفي والتربية العاطفية
ما الذي يتنبأ بالنجاح في المستقبل؟ بالتأكيد، هنالك العديد من العوامل التي تتنبأ بشكل أو آخر بنجاح أبنائنا وبناتنا، إلا أن التحصيل الدراسي يكاد يحتل المرتبة الأولى من وجهة نظر أولياء الأمور وحتى بعض المُربين. لقد تَعلمنا منذ الصغر أن التحصيل الدراسي (خاصة في المرحلة الثانوية) سيضمن لنا النجاح في المستقبل... هكذا علمونا. إلا التحصيل الدراسي، وعلى الرغم من أهميته، فإن التركيز عليه بشكل مفرط قد يكون ضاراً على طلبتنا من الناحية النفسية، ومن الناحية المهنية مُستقبلاً.
من أجل التحصيل الدراسي، فإننا نقوم بالضغط على أبنائنا وبناتنا ليحصلوا على ٤/٤، أو ١٠٠٪. اثنتا عشرة عاماً يقضيها أبناؤنا وبناتنا على مقاعد الدراسة—إذا استثنينا التعليم ما قبل المدرسة—هي سنوات مليئة بالضغوط النفسية لأننا جميعاً نود أن يكون أبناؤنا من الأوائل، متجاهلين حقيقتين أساسيتين: (١) أن هنالك فروقاً فرديةً بين البشر في جميع القدرات المعرفية وغير المعرفية، (٢) وأن النظام التعليمي الذي يحصل فيه الجميع على ١٠٠٪ ليس له وجود! حسناً، إن كان الأمر كذلك—أي أن المعدل الدراسي المرتفع يتنبأ بالنجاح في المستقبل—فلا بأس ببعض الضغط على أبنائنا من أجل مستقبلهم، إلا أن مدرسة الحياة والتجارب الواقعية يخبراننا أن النجاح في المستقبل يتطلب ما هو أكثر من مجرد التحصيل المرتفع. أتناول فيما يلي أحد أهم عوامل النجاح في المستقبل، ألا وهو الذكاء العاطفي.
في العام ١٩٩٥، نشر عالم النفس والمؤلف الشهير دانيال جولمان أحد أكثر الكتب مبيعاً بعنوان: لماذا قد يكون الذكاء العاطفي أكثر أهمية من معامل الذكاء؟ إذا أمعنّا النظر في الحياة الواقعية، فسوف ندرك أن متطلبات النجاح تفوق التحصيل الدراسي والمعرفة المتقدمة التي قد لا نستخدم بعضها أبداً بعد التخرج من المدرسة أو الجامعة. إن من أسباب النجاح في الحياة الواقعية هي قدرة الفرد على إدراك مشاعره ومشاعر الآخرين، قدرته على إدارة الضغوط، قدرته على التعاطف مع من هم حوله، إضافة إلى قدرته على التكيف مع متغيرات الحياة. كل ما سبق يُشكل ما يُعرف اليوم بالذكاء العاطفي الذي، ومع الأسف، ليس له مساحة واسعة في التعليم محلياً وعالمياً.
إن الذكاء العاطفي مُهمٌ للمُعلم ليتفهم مشاعر طلبته ويتعاطف معهم عندما يتعرضون لمشكلة أو إخفاق ما، كما أنه مُهمٌ للطبيب عندما يتعامل مع الحالات الحرجة أو المستعصية، وكذلك هو مُهمٌ لجميع التخصصات الأخرى التي تتطلب التواصل الفعَّال بين الفرد والآخر. إن التعامل مع الطلبة على أساس الدرجات وأنهم أرقام يدل على عدم النضج، وهو بعيدٌ جداً عن جوهر وأهداف التعليم. كما أن هوس التحصيل المرتفع قد يُولد أجيالاً من الطلبة يعانون من أمراض نفسية وصحية، لأنهم وبكل بساطة مشغولون طوال وقتهم بالدراسة والتحصيل والخوف من العقاب. في دراسة حديثة حول الطلبة الموهوبين والذين هم أكثر حساسية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، فقد أشارت النتائج أن الكمالية الزائدة لدى بعض الطلبة، إضافة إلى الضغوط النابعة من التعليم القائم على الاختبارات قد يؤديان إلى بعض الأمراض الجسدية، منها أمراض القلب. ليس المقصود هنا إهمال التحصيل الدراسي، بل توعية المُربين وأولياء الأمور لحقيقة أن النجاح في المستقبل لا يرتبط بالتحصيل فقط، بل أن هنالك عوامل أخرى كالتربية العاطفية والذكاء العاطفي. إن التربية العاطفية تعني تقبلك وحبك غير المشروط لابنك وابنتك، لطالبك وطالبتك، بغض النظر عن أدائهم التحصيلي. جميعنا نحمل بعض الذكريات لأساتذة مروا علينا وكان لهم دور كبير في حبنا لمادة أو مقرر ما، لأنهم وبكل بساطة لم يتعاملوا معنا كأرقام، بل بأشخاص لهم حاجاتهم النفسية والعاطفية. في إحدى المرات سألتني ابنتي، ما هي الدرجة التي سوف تجعلك فخوراً بي، فكانت الإجابة: أنا فخور بك بغض النظر عن درجتك.
إن التربية العاطفية هي إحدى الجوانب التي قد نهملها نتيجةً لانشغالنا بحل الواجبات مع أبنائنا إلى درجة أننا ننسى، أو قد لا يسمح لنا الوقت بالسؤال عنهم، بالحديث معهم، وباحتضانهم ومداعبتهم. قصة أخرى رُويت لي من أحد الأشخاص أنه اختار التقاعد المبكر من أجل أن يتمكن من توصيل أبنائه واستلامهم من المدرسة يومياً بعدما تغيرت أوقات انصراف أبنائه نظراً لاختلاف مراحلهم الدراسية، وتعارض ذلك مع توقيت عمله. لقد تعلمت من هذا الشخص الذي لا يحمل سوى شهادة الثانوية العامة، أن فقرة الذهاب إلى المدرسة مع الأب أو الأم هي أكثر فترات اليوم أهمية لدى الأبناء، وهي التوقيت الأمثل لزراعة القيم والمبادئ وتقليل التوتر الناتج عن الاختبارات والقلق المصاحب لعدم فهم جزئية معينة من المادة التعليمية.
اختم بالقول أن الذكاء العاطفي، ولحسن الحظ، هو أمر يمكن تنميته لدى الطلبة في جميع المراحل الدراسية وكذلك لدى الموظفين والعاملين، وأن هنالك العديد من المصادر المتخصصة بكيفية تنشئة أطفال يتمتعون بالذكاء العاطفي، كما أن هنالك برامج تنفيذية خاصة بالذكاء العاطفي تطرحها بعض الجامعات المرموقة عالمياً كجامعات هارفرد وأريزونا وأوكسفورد. أخيراً، تذكر/تذكري أن أحد أهداف التعليم ليس حصول جميع الطلبة على درجات عالية، بل غرس حب التعلم لأن التعلم المبني على الشغف والاهتمامات هو بكل تأكيد أشد أثراً وأكثر فاعليةً من التعليم المبني على الخوف من الفشل.
البذرة الواعدة
هل حان الوقت لوزارة للابتكار الحكومي في مملكة البحرين؟
نعم... إنهن مبدعات
يدور التساؤل التالي في الأوساط العلمية وفي المجتمعات بشكل عام: هل الذكور أكثر إبداعاً من الإناث؟ تعود جذور هذا التساؤل عندما نشر السير فرانسيس جالتون، عالم النفس الشهير كتابة "العبقرية الموروثة" في العام ١٨٦٩ والذي دَرس من خلاله سِيَرَ العشرات من الرجال في مجالات شتى، كالآداب والعلوم والموسيقى. أما النساء، فلم يكُن لديهن نصيبٌ من العبقرية بحسب جالتون. لاحظ/لاحظي أن جالتون استخدم كلمة العبقرية، ذلك لأن علم الإبداع ظهر بعد نشر جالتون لكتابة بخمسين سنة تقريباً. أما الكاتب مايكل هارت، صاحب الكتاب الشهير "ال ١٠٠" والذي صنَّف فيه أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في التاريخ فلم يذكر في قائمته أي امرأة. وبعيداً عن العلماء وما يعتقدونه، فهذا مثال واقعي من تجربة كاتب المقال من خلال تدريسه لمقرر الإبداع لطلبة الدراسات العليا. في بداية كل مقرر وعلى مدار السنوات الست التي قضاها الكاتب في تدريسه لهذا المقرر، كان من ضمن الأسئلة التي يوجهها للطلبة هو: خلال دقيقة واحدة، أذكر/اذكري أكبر عدد ممكن من الأشخاص المبدعين. هذا وعلى الرغم من أن أغلبية الطلبة هنَّ من الإناث، إلا أنه وفي كل عام، لا يكون من ضمن القائمة أي امرأةٍ مبدعة. لذا فإن السؤالين اللذين يهدف هذا المقال للإجابة عليهما: (١) هل الذكور أكثر إبداعاً من الإناث من ناحية القدرة العقلية أو ما يطلق عليه بالإمكانية الإبداعية؟ إن كانت الإجابة نعم، فقد حُسمت القضية، أما إن كانت الإجابة لا، فالسؤال الذي يجب الإجابة عنه هو: ما الذي يحول دون وصول الإناث لمستوى الإبداع؟
قبل المضي في الإجابة عن هذين التساؤلين، فمن الجيد التطرق إلى تعريف الإبداع ومستوياته، حيث أن هنالك فروقاً جوهريةً بين مصطلحات الإبداع والذكاء والموهبة وغيرها. اختصاراً، فإن غالبية العلماء يُعرفون الإبداع بأنه قدرة الفرد على توليد الأفكار أو المنتجات الأصيلة والمفيدة (التي تتسم بالفاعلية)، ذات العلاقة بالسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد. الأصالة (أو ما يطلق عليه البعض التفكير خارج الصندوق) هو جوهر الإبداع، ولكن يجب أن تكون الفكرة أو المنتج الأصيل مفيداً وذو فاعلية (قابلاً للتطبيق). أخيراً، فإن السياق الاجتماعي مهم عند النظر للأفكار والمنتجات الإبداعية، فما قد يكون فكرة أصيلة في مجتمع ما، قد لا يكون كذلك في مجتمعات أخرى لاعتبارات ثقافية أو فكرية أو غيرها.
نتطرق الآن لقضية جوهرية عند مناقشة الفروق في الإبداع بين الذكور والإناث ألا وهي مستويات الإبداع. أولاً، وبحسب بول تورانس والذي يُطلق عليه بالأب الروحي للإبداع في العصر الحديث، فكل شخص مبدع سواء أكان ذكراً أم أنثى، ولكن الفرق في الدرجة وليس في تواجد القدرة من عدمه. هذا وقد قَسَّمَ عدد من العلماء الإبداع لأربعة مستويات. أولها ما يطلق عليه (الميني-سي)، ويُقصد به العشور الداخلي للشخص المبدع عند المرور بخبرة إبداعية وما تضيفه هذه الخبرة للشخص المبدع. التصنيف الثاني المتداول في بحوث الإبداع هو "الإبداع اليومي" أو ما يعرف بال(ليتل-سي). ماذا عن الأشخاص الذين يقومون بتوليد أفكار جديدة وغير تقليدية دون أن تتحول أفكارهم إلى منتجات فعلية؟ أو ماذا عن تلك المرأة المعروفة بأطباقها الشهية والتي "تبدع" في دمج مكونات الطعام لكنها لم تقم بافتتاح مطعم ناجح يتميز بأطباقه غير التقليدية؟ أو ماذا عن تلك التي تبدع في خياطة الملابس التراثية أو تصميم الأزياء عموماً من دون أن يكون لديها محل لبيع منتجاتها الإبداعية؟ وماذا عن الأشخاص الذين يبرعون في حل المشكلات التي تواجههم بشكل يومي وينجحون في الوصول إلى حلول أصيلة وناجعة لهذه المشكلات أو التحديات اليومية؟ هل نطلق على مثل هؤلاء "مبدعين" أم أنهم لا يستحقون مثل هذا الوصف؟ الإجابة هي قطعاً نعم طالما أن هذه الأفكار تتسم بالأصالة والمنفعة. المستوى الثالث من مستويات الإبداع هو ال (برو-سي) وهو للأشخاص المتخصصين في كافة المجالات والذين تجاوزوا مستوى الإبداع اليومي من خلال أفكار ومنتجات أصيلة وفعالة، إلا أنه (لسبب أو آخر) لم يتم إدراك إبداعهم من قبل الآخرين على أنه إبداع من المستوى الكبير (البيغ-سي)، وهو المستوى الرابع والأكثر وضوحاً، وهو الخاص بالمبدعين على المستوى التاريخي في مختلف المجالات كبيكاسو وابن سينا ودافينشي وستيف جوبز وخالد بن الوليد.
لنناقش السؤال الأول وهو المحك عند مناقشة الفروق بين الذكور والإناث في الإبداع: هل الإمكانية الإبداعية لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث؟ حتى العام الماضي، كان هذا التساؤل من أكثر القضايا الشائكة في علم الإبداع، ولكن مع نشر دراسة تحليلية ضخمة في العام ٢٠٢٢ لكاتب المقال تلخص الفروق بين الذكور والإناث في القدرة (الإمكانية) الإبداعية، فقد تم حل هذا الخلاف بشكل قطعي. يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة التي تم نشرها في أرقى دورية علمية تابعة للجمعية الأمريكية لعلم النفس في التالي: بعد تحليل نتائج ٢٧١ دراسة سابقة شارك فيها أكثر من مائة ألف طالب وطالبة من مختلف دول العالم، فأشارت النتائج أن الإناث يتفوقن على الذكور (وإن كان ذلك بنسبة بسيطة) في الإمكانية الإبداعية. السؤال التالي الذي يتوجب على العلماء الإجابة عنه هو: إذا كانت القدرة الإبداعية لدى الإناث متساوية أو أعلى بقليل من الذكور، فلماذا لا يظهر ذلك بشكل واضح خاصة في مستوى الإبداع الكبير؟ انظر/انظري لأسماء الفائزين بجائزة نوبل على سبيل المثال لآخر ١٠ سنوات. لمِ الذكور أكثر تمثيلاً من الإناث؟ حسناً، ان هذا مقال نظري ولا يمكن الإجابة عن مثل هذا التساؤل من خلال الأدلة القولية، ولكن الأدب التربوي الخاص بالإبداع يقترح بعض الأسباب، والتي سوف أقوم بتلخيصها بإيجاز غير مخل إن شاء الله.
لنبدأ بالفرص المتاحة لكلٍ من الذكور والإناث (على الرغم من تقلص الفجوة في الوقت الحالي). تاريخياً، تشير أغلب المصادر إلى عدم تساوي الفرص بين الذكور والإناث، كتوفير الأدوات المناسبة للإبداع في مجال ما، إلى الفرص في التعليم والاطلاع على المعرفة، والفرص في استكشاف العالم، والفرص في التوظيف (مفهوم المرأة العاملة هو مفهوم جديد نسبياً). إن عدم توافر أو تساوي الفرص لم يكن حكراً على البيئة العربية، بل كان كذلك صحيحاً حتى وقت قريب في دول أوروبا والعالم الغربي. مثال على ذلك قصة فلم "شخصيات مطموسة" والذي يحكي قصة ثلاث نساء مبدعات أسهمن في إطلاق أول قمر صناعي أمريكي وتم نشر القصة حديثاً. وأنظري لفلم "لعبة المحاكاة" في الدقيقة ال ٣٠ من الفلم عندما اقتحمت إحدى الإناث قاعة الاختبار الخاص بحل الكلمات المتقاطعة. كان ذلك غريباً وغير مسموح به في بريطانيا العظمى! وبعيداً عن الأفلام، فلولا الفرصة التي حصل عليها تشارلز داروين في السفر لأكثر من ٣ سنوات متنقلاً بين البحر واليابسة لما طور نظريته ونشر كتابه الشهير "أصل الأنواع." بكل تأكيد، ومع الجهود المبذولة عالمياً ومحلياً، فقد تقلصت الفجوة في الفرص بين الذكور والإناث، ويُتوقع بروز العديد من المبدعات في مختلف المجالات والحقول العلمية والأدبية خلال السنوات القليلة القادمة.
السبب الثاني هو التوقعات. وللاختصار، عندما لا يتوقع من المرأة أن تقوم بأعمال إبداعية، هل سوف يلاحظها أو يدعمها أحد؟ هنا، لا زالت النظرة الشرقية مؤثرة من ناحية التوقعات، وقد يكون من الجيد إجراء دراسة لمعرفة واقع (التوقعات) من المرأة في البيئة الشرقية ومقارنتها بالبيئة الغربية.
أخيراً، وهي النقطة ذات الصلة بمستويات الإبداع، فهنالك فهم مغلوط مفاده أن الحكم على الإبداع مرهون بالفوز بالجوائز العالمية أو من خلال براءات الاختراع، وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للرجال، ولكنه ليس بالضرورة دقيقاً عند وصف الإبداع عند المرأة. إن الإبداع ليس محصوراً على الإبداع من المستوى الكبير (البيج-سي)، ولو كان كذلك لما كانت هنالك حاجة لدراسة علم الإبداع، ذلك أن الأشخاص مثل ستيف جوبز ودافنشي وامرؤ القيس وابن سينا قليلون من الناحية التاريخية. من هنا، يتحتم تثقيف المجتمع أن للمرأة خصوصية في تعبيرها عن سلوكها الإبداعي. فتلك المرأة غير العاملة والتي تقضي معظم وقتها بتربية أبنائها (كأمهاتنا في السابق) وتحل مشكلاتهم بطرق غير تقليدية، وتجد لمستها في كل شبر من زوايا المنزل هي امرأة مبدعة، ولا ريب. ذلك ينطبق على المرأة العاملة التي توازن بين عملها وبين واجباتها المنزلية، وعلى الرغم من عدم تواجدها في المنزل لساعات طويلة إلا أن لمساتها على سبيل المثال في الديكور أو اختيار الألوان أو ترتيب الأثاث بشكل غير مألوف هي جميعاً إبداعات حقيقية ولكنها غير ظاهرة للمجتمع. إن عدم معرفة الآخرين بإبداع المرأة لا يعني بأنها ليست مبدعة: إنها مبدعة بأسلوبها ووفق ما يتاح لها من وقت ومصادر ودعم، وبشهادة القريبين من حولها.
هذا تلخيص لموضوع قد يحتاج لكتاب متكامل للخوض في جميع تفاصيله، وهنالك المئات من البحوث التي أعرضت عنها خشية الإطالة، ولعل وضعها في قائمة المراجع أدناه يكون جيداً لمن لديه الشغف بمعرفة المزيد حول الفروق في الإبداع بين الذكور والإناث.
ختاماً، ومع الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات التي تعنى بالمرأة في العالم، ومثال على ذلك ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، فمن المتوقع أن تقل فجوة الإبداع بين الذكور والإناث في مستوى الإبداع الكبير. إن الرهان الأول هو في التعليم وذلك من خلال اكتشاف الموهوبات والمبدعات من عمر مبكر، ومن ثم وتقديم خدمات وبرامج مدروسة وفرص نوعية تتيح لكل طفلة اكتشاف جانب الإبداع (الشغف) لديها لتساهم في نهضة مجتمعها المعروف بإبداعه وإنتاجه الأصيل.
المراجع
Abdulla Alabbasi, A. M., Runco, M. A., AlSuwaidi, H.N., & Alhindal, H. S. (2018). Obstacles to personal creativity among Arab women from the GCC countries. Creativity. Theories-Research-Applications, 5, 41-54. DOI: 10.1515/ctra-2018-0003
Abdulla Alabbasi, A. M., Thompson, T., Runco, M. A., Alansari, L., & Ayoub, A. (2022). Gender differences in creative potential: A meta-analysis of mean differences and variability. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/aca0000506
Abraham, A. (2016). Gender and creativity: An overview of psychological and neuroscientific literature. Brain Imaging and Behavior, 10(2), 609-618. https://doi.org/10.1007/s11682-015-9410-8
Baer, J. (2012). Gender differences in creativity. In M. A. Runco (Ed.), Creativity research handbook, Vol. 3 (pp. 215-250). New York, NY: Hampton Press.
Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92-96. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092
Runco, M. A., Cramond, B., & Pagnani, A. R. (2010). Gender and creativity. In J. C. Chrisler & D. R. McCreary (Eds.), Handbook of gender research in psychology, Vol. 1 (pp. 343-357). New York, NY: Springer.
Taylor, C. L., & Barbot, B. (2021). Gender differences in creativity: Examining the greater male variability hypothesis in different domains and tasks. Personality & Individual Differences, 174, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110661
Thompson, T. L., Pfeiffer, S. I., & Choi (2021). The mothers and fathers of invention: A meta-analysis of gender differences in creativity. [Manuscript submitted for publication]. Department of Educational Psychology & Learning Systems, Florida State University.